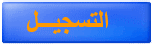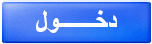في الآونة الأخيرة أصبحت البيئة وما تواجهه من أزمة صحية وتنموية، حديث المنتديات والمؤتمرات والشغل الشاغل للناس وللكتاب على السواء.
والسؤال الذي يحضر من غير استئذان: ما الذي تحقق للبيئة من خلال كل هذا؟.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أنا لا أملك أرقاماً وبيانات لأدلل بها على تقصير المسؤولين في تطبيق التوصيات التي يخرجون بها من منتدياتهم ومؤتمراتهم الدولية والمحلية، لكنني بلا شك أملك أنفاً أتنفس من خلاله، وعينين أرى بهما، وجسداً أحيا به. ولهذا أجزم بأن البيئة في بلدي ملوثة ومدنسة، وبأن الطبيعة أرضاً وشجراً وماء وهواء مدمرة بالإهمال وبالنفايات. فما يقال في المحافل الرسمية عن أهمية البيئة وضرورة العناية بها ما هو إلا نفاق، ما دامت العناية بها غائبة. وهذا يؤشر إلى واقع، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه بعيد عنه أو بريء منه.
فدمشق التي كانت روحاً وريحاناً وجنات نعيم، غاب عنها التنوع الحيوي وطغت على طقسها تبدلات مناخية قاسية. فهي اليوم نتيجة الزيادة السكانية، صحراء إسمنتية غاب نهرها وجف ياسمينها وتبددت غوطتها وهجرت منازلها أشجار النارنج والإكي دنيا، وشققت المياه المالحة تربتها ولوثت عوادم السيارات هواءها.
قد يكون لمجتمعنا من الأمان والتلاحم أكثر من أي مجتمع آخر، إلا أن نوعية الحياة فيه تفقد من قيمها بسبب أكوام الفضلات العضوية التي نراكمها بأيدينا. إلى جانب ازدياد عدد السيارات، واكتساب المزيد من الأبنية والقصور على حساب المساحات الخضراء.
وإذا كانت البيئة في الدول الصناعية الكبرى تعاني من المواد الكيماوية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، فإن معاناتنا في سورية هي من فعل أيدينا. ناتجة عن هباب السيارات وعن رمي الأوساخ في الشوارع والطرقات. فلو تهيأ لسكان في دمشق مركبات عامة بمواصفات عالية ومنظمة مكاناً وزماناً، لتشجع أصحاب السيارات الخاصة على استخدامها، وانخفضت بالتالي نسبة التلوث بالهباب الأسود.
في الطريق التي تحيط بساتين الصبار في منطقة المزة، ترتفع لافتة تنهي عن رمي الأتربة وتتوعد كل من يقوم بذلك بعقوبة رادعة. فأبتسم حزناً وأنا أرى مخلفات ترميم الأبنية مرمية على الجانبين أكواماً أكواماً، فلا المواطن يبالي بالتنبيه والتهديد، ولا الجهة المعنية تتابع المخالفين وتعاقبهم.
في كتاب (التصحر) الذي صدر عام 1999عن سلسلة عالم المعرفة، ميز الكاتب محمد القصاص بين ثلاث منظومات تعد الأساس في أي معالجة أو نقاش لإشكالية التنمية والبيئة، وهي:
المحيط الحيوي: وهو الحيز الذي توجد أو يمكن أن توجد فيه الحياة. وهو الممتد من طبقات الهواء القريبة من الأرض إلى الأرض ذاتها، والطبقات السطحية من الماء.
المحيط التكنولوجي: وهو ما أنشأه الإنسان من أدوات ومنشآت في المحيط الحيوي، مثل المساكن والمزارع وطرق المواصلات ومشروعات الري والصرف والمصانع ومحطات الطاقة وسوى ذلك.
المحيط الاجتماعي: الذي يشمل علاقات الأفراد والتجمعات البشرية بكل أنواعها، والمؤسسات والنظم والقيم التي تحكم التفاعلات مع المحيطين الآخرين. أي جماع المؤسسات والقدرات الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المجتمع، ويشمل هذا العقائد والأديان والدساتير والقوانين والتحولات السياسية الجارية.
وإذا نظرنا في هذه المنظومات، نجد أن المحيطين الحيوي والاجتماعي قديمين قدم الكون والإنسان. أما الجديد على الساحة الذي يجب التركيز عليه، فهو المحيط التكنولوجي. لكن هذا لا يعني أن نتجاهل تفاعله مع المحيطين الآخرين لأن تفاعلاته في المحيط الحيوي وفي المحيط الاجتماعي هي لب المشكلة بمثل ما هو طريق البحث عن حلول .
وعلى هذه المنظومات يعلق الدكتور أسامة الخولي في كتابه (البيئة وقضايا التنمية والتصنيع)، فيقول:
إن نشاط الإنسان في المحيط التكنولوجي، يهدف أساساً إلى الوفاء بمتطلبات المجتمع من السلع والخدمات بكل أنواعها. وحتى يحقق هذا، فإنه يتدخل في المحيط الحيوي ويستغل بعض مكوناته لتوفير هذه المتطلبات. وفي المحصلة يلفظ مخلفات صلبة وسائلة وغازية، تعود ثانية إلى المحيط الحيوي. لهذا يجب أن تقيد النشاط في المحيط التكنولوجي، عدة محددات كامنة في خصائص النظام الحيوي لا سبيل إلى تجاوزها:
• حسن استخدام الموارد وتحسين الأداء في استخدامها، وإعادة تدوير المخلفات لتكون صالح للاستخدام مرة أخرى. أو في السعي، للبحث عن بدائل للموارد التقليدية. فقدماء المصريين على سبيل المثال لم يعرفوا الحديد إلا في مرحلة متأخرة جداً، والنفط لم يستعمل وقوداً على نطاق واسع إلا في النصف الثاني من القرن الماضي، على الرغم من أنه كان معروفاً منذ آلاف السنين.
•عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تعويض ما يؤخذ منها، كأن لا يتجاوز حجم المصيد من بحر أو نهر قدرته على تكاثر الأسماك. أو ما يقطع من أشجار الغابات، قدرتها على نمو أشجار بديلة. أو ما تتغذى به حيوانات الرعي في أحد المراعي، القدرة على إنتاج الكساء النباتي.
• ألا تتجاوز المخرجات من المخلفات بأنواعها قدرة المحيط الحيوي على استيعابها بشكل أو بآخر لكي لا ينتج ضرراً لا سبيل إلى إصلاحه في المحيط وتترتب عليه آثار تضر بالإنسان.
إن الإبداع التكنولوجي للإنسان نشاط لا ينتهي، إلا أن حجمه وتوجهاته يتأثران بما يجري في المحيط الاجتماعي الذي يحدد ما يتوافر لهذا النشاط من موارد. فالتكنولوجيا في حد ذاتها محايدة ، أي أنها لا تحمل قيماً اجتماعية أو ثقافية، وإنما الذي يحدد استخداماتها ومن ثم فوائدها أو مضارها، هو الهدف الذي تستخدم من أجله. وكما يمكن أن تكون ضارة بالبيئة، يمكن أن تكون وسيلة لإعادة التوازن البيئي المطلوب أو التخفيف من حدة الخلل الذي يطرأ عليه.
إن دراسة العلماء للبيئة وما تواجهه من مشكلات ليس عملاً استعراضياً، ولا عملاً منفصلاً عن التنمية، وإنما هي تعبير عن الاهتمام بالحياة عموماً. فالبيئة لم تعد مجرد هواء ملوث ومياه عكرة بل هي أكثر من ذلك، إنها قضية تتعلق بالحاجات الأساسية للإنسان وبأوضاعه الصحية والاجتماعية. فلعلماء يعملون على استمرار الحياة فوق هذا الكوكب، الذي أوكل الله أمره للإنسان واستخلفه عليه، كما جاء في القرآن الكريم:
“وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة...”سورة البقرة/30
“ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون”سورة يونس/14
وكما جاء في العهد القديم:
“أخذ الله الإنسان ووضعه في جنة عدن ليعمرها ويكون قيّماً عليها.”سفر التكوين 2/15
إن التغير البيئي الحاد الذي نلحظ آثاره يجعلنا نفكر بجدية بمستقبل أولادنا وأحفادنا، ويعيدنا إلى
سنوات ماضية كانت فيها دمشق قبلة الناس في الداخل وفي الخارج.
وكم أتمنى أن تضع وزارة التربية في المناهج المدرسية حصة تهتم بتنمية الوعي بالقضايا البيئية بأسلوب مفهوم ومبسط، تنبه الطلاب إلى أن ما يفعله كل واحد منهم في محيطه الصغير تصل آثاره إلى الوطن بأكمله.
فلو عدنا إلى الماضي من خلال الأمثال الشعبية المتعلقة بالأحوال الجوية، لوجدنا أنها تعبر عن حالة مناخية متوازنة. فالصيف كان صيفاً والشتاء كان شتاء وهكذا. أي أن الفصول الأربعة كانت واضحة المعالم في بلادنا وليس هناك فصل يطغى على الآخر، وهذا بالتالي ينعكس على المواسم الزراعية وعلى التنمية الاقتصادية. أما اليوم فأسوأ ما يحدث للمجتمع هو تراجع الموسمية التي حاول بعض المزارعين التغلب على فشلها ببيوت بلاستيكية ملأت السهل الساحلي، فشوهت منظره ولوثت البيئة فيه ومن حوله.
قال لي صديق عن فتاة أجنبية عاشت في دمشق عدة سنوات بحكم عملها في سفارة بلدها، أنها كتبت في أوراقها قصة للأطفال على لسان (دبّة) تحكي فيها عن إقامتها بدمشق وزينتها بالصور التي التقطتها للشوارع والطرقات. وفحوى القصة أن هذه الدبّة زارت دمشق وتعرفت إلى أهلها، فوجدت عشرتهم طيبة ومنازلهم جميلة وطعامهم لذيذاً. لكن رؤية الأوساخ المتناثرة في الشوارع والأزقة والزوايا والمنحنيات أزعجتها كثيراً، حتى اعتقدت أن هذه الحالة هي جزء من ثقافة السوريين وتراثهم. وختمت الدبة القصة بقولها: إن صادف وعدت إلى دمشق ثانية، فأخشى ما أخشاه أن أراها غارقة في طوفان من النفايات.!
بالله عليكم، ألا تستحق دمشق أن نلتفت إليها وأن نحتضنها بالأيدي النظيفة والقلوب المحبة؟!